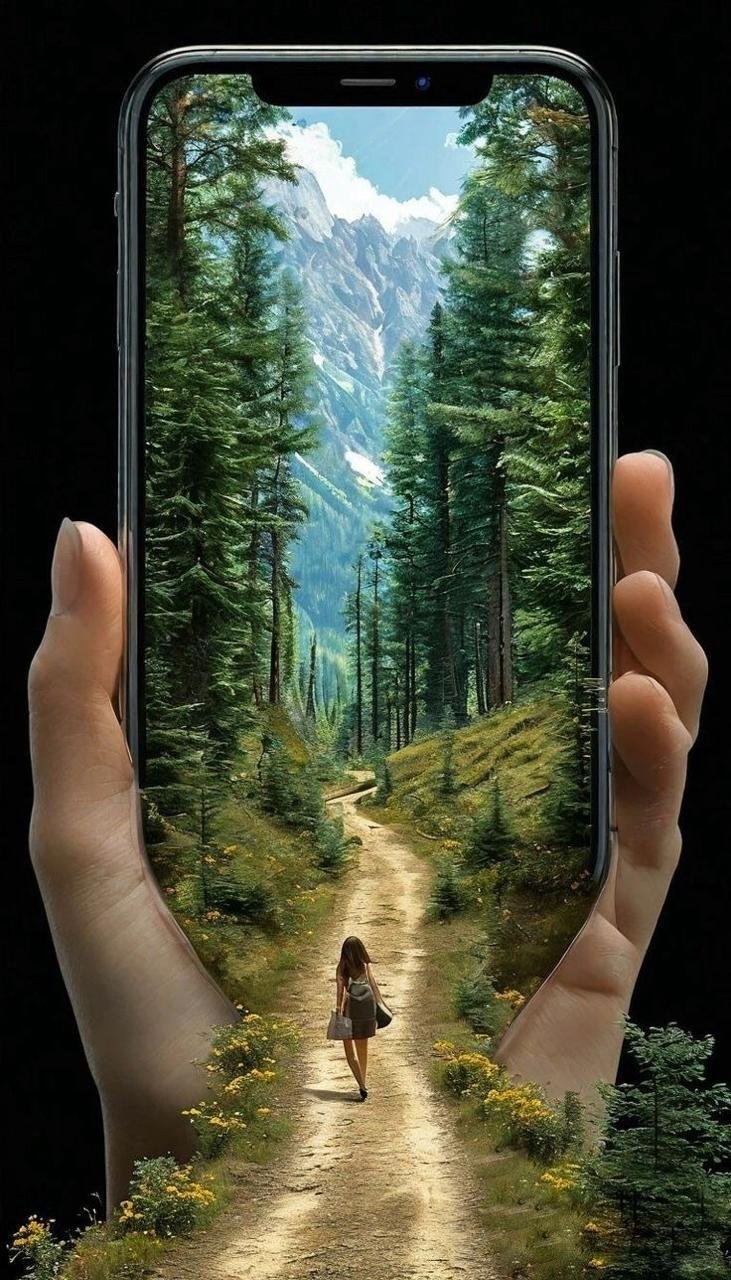غياب الظل والفقدان الوجودي في شعر دخيل الخليفة

د. آمال بوحرب
في عالم الشعر يُعد الفقد والوجع محورين أساسيين يعبران عن الوجود الإنساني المعذب حيث يتحول الشعر إلى مرآة تعكس الفراغ الداخلي والاغتراب عن الذات والعالم منذ القدماء مثل امرئ القيس الذي يبكي على الأطلال كرمز لفقدان الزمن والحبيب مروراً بأدونيس الذي يجعل المنفى وجعاً وجودياً يتردد في “أغاني مهيار الدمشقي” إلى الشعراء المعاصرين الذين يستلهمون الحروب والتهجير ليصوروا الفقد كجرح مفتوح يعيد تشكيل الهوية هذا الوجع ليس مجرد عاطفة بل هو بحث فلسفي عن المعنى في الغياب يتجلى في صور جسدية مشوهة وفضاءات مهجورة مما يدفعنا إلى التساؤل كيف يحول الشاعر الفقد إلى أداة معرفية ووجودية لاستكشاف الذات الممزقة من هنا ننطلق إلى نصوص دخيل الخليفة الشاعر الكويتي لنبني قراءة إبستمولوجية ونتعرف على كيفية تشكل المعرفة عبر الفقدان وماهية العزلة الوجودية ؟
وإلى أي حد يجوز اعتبار العبث جوهر للكينونة مع من خلال الدمج السيميائي للرموز؟
الفقد أداة معرفية ووجودية
في نصوص دخيل الخليفة يتداخل البعد الإبستمولوجي بالوجودي ليصبح الفقدان أداة معرفية حيث يتحول الجسد المشوه إلى مصدر إدراك معيب كما يظهر في قصيدة «أصابع» حين يقول «لديّ تسع أصابع والعاشرة وطن مفقود» يتحول الغياب إلى شرط للإدراك وتصبح العزلة عبثية على طريقة سيزيف فيما يشير العكاز في «خطوات على عكاز» إلى الصمود أمام الفراغ وفي «عزلة كائن الجمر» يظهر الفقدان معرفيًا كاختطاف فاشل ووجوديًا كحرية مرعبة بينما في «فقدت رأسي في حرب» تتحول الحرب إلى كارثة إبستمولوجية والصعود السيزيفي إلى الأسفل تجسيدًا للهاوية أخيرًا في «سجن» يصبح القفص المفتوح رمزًا لمعرفة معكوسة حيث الهروب ذاته سجناً والحرية جرحًا لا يحرر هكذا يقاوم الشاعر اللامعنى ببناء معنى من الجرح مستلهمًا التراث العربي ومتقاطعًا مع الفلسفة الغربية ليصير الفقدان تجربة معرفية ووجودية وسيميائية متكاملة.
التفكك والكينونة: قراءة مدمجة إبستمولوجية وسيميائية ووجودية لكل قصيدة
في قصيدة «أصابع» يتحول فقدان الجسد إلى مدخل معرفي يكشف عن نقص مستمر إذ يرمز نقص الأصابع إلى غياب الوطن كأساس للإدراك وإنه على المستوى الوجودي تكشف العزلة السيزيفية عن فراغ يعيد تشكيل الوجود كمسيرة بلا ظل ومن منظور إبستمولوجي يعكس فقدان “الأصبع العاشرة” معرفة مفقودة تجعل الجسد مصدر إدراك معيب وقد يحاول الشاعر إعادة بناء وعيه داخليًا بـ”أخبئُ رأسي في قلبي” عبر “أغنية قديمة” كأداة ذاكرية ولكن الشوارع “بلا قلب” تكشف فشل هذا البناء مما يجعل الوعي مشتقًا من الغياب ويدرك العالم كـ”جسد بلا ظل” في معرفة سلبية قائمة على الظلال لا الجوهر وإنه سيميائيًا يصبح “التسع أصابع” دالًا رئيسيًا على النقص الدلالي حيث يرمز الجسد إلى “الوطن المفقود” كمدلول سياسي-ثقافي للمنفى بينما تمثل “الشوارع اليتيمة” رموزًا أنثروبومورفية تكشف تفكك الهوية الجماعية وتعمل “الأغنية القديمة” كعلامة أرشيفية لترميم الدلالة المفقودة وقد يكشف “الجسد بلا ظل” عن انفصال الدال عن المدلول في نظام سيميائي قائم على الغياب أما وجوديًا فتتحول العزلة إلى مسيرة سيزيفية وعندما يسير الشاعر “لوحدي” في عالم يتجاهل الذات يتولد غثيان أمام الفراغ وتتصرف الشوارع “تتلفتُ” ككائنات ترفض الرفقة إذ إن الفقدان يعيد تعريف الحياة كـ”وطن مفقود” دون معنى خارجي مذكرًا بالقَلَق الوجودي عند كيركغور أمام الفراغ.
خطوات على عكّاز: الالتقاط في فضاء الغربة
يتحول الشارع إلى مخزن لشظايا المعرفة الجماعية ولكنه يبقى فاشلاً في ترميم الوعي المتشظي وإنه تعكس الغربة الأبدية كينونة مشاركة في العبث حيث يصمد الجسد المعطل أمام الفراغ وإبستمولوجياً يمثل الشارع فضاءً للمعرفة الجماعية المتناثرة حيث يلتقط الشاعر “أحلام العابرين” و”نجوم التي سقطت” كشظايا وعي مفقود في عملية تراكمية فاشلة مبنية على تراكم تاريخي للألم مثل “أصوات من ماتوا” و”دمعة أمي” مع “العكاز” كرمز للإعاقة المعرفية وقد يصبح الظلام مصدراً مشوهاً للمعرفة وإنه سيميائيًا يعكس “الالتقاط” عملية دلالية متكررة حيث تتحول “أحلام العابرين” و”النجوم الساقطة” إلى رموز لدلالات متناثرة تدل على تاريخ الاضطهاد بينما تمثل “خيول الرفاق” علامة على الخيانة ويصبح “العكاز” دالاً على الإعاقة الدلالية في حين يشير “القلب المتخشب” و”العينين من شمع” إلى تحول الجسد إلى رموز اصطناعية للاغتراب وإنه عندما تصير “الغربة ثوب بشر بلا ملامح” يكون الانفصال بين الدال والمدلول تامًا وجوديًا يصور الفقر والغربة كوجود جذري عبثي وعندما “الليل ينام جائعاً” و”الفقير ينام عارياً” تشارك الطبيعة في الاغتراب ويصبح الالتقاط “قلباً متخشّباً” كرفض للوهم.
عزلة كائن الجمر: الاحتراق في الصمت
غالبا ما تتحول ذاكرة الهروب والمعرفة إلى عملية فاشلة مليئة بالتناقضات الداخلية إذ تصبح العزلة احتراقًا يولد تمردًا وجوديًا ضد اللامعنى ويصبح البكاء صرخة ذئبية إبستمولوجيًا تكون الذاكرة غصنًا هاربًا فرّ مما يجعل المعرفة اختطافًا فاشلًا حيث تتحول أدوات الإدراك إلى معطلة مثل “الصمت غابة” و”عود كبريت لا يُضيء الكهولة” فيبحر الشاعر بلا اتجاه في “حكايات النار” المشبعة بالتناقض ويصبح البكاء مثل ذئب طعنته الفريسة كاشفًا معرفة معكوسة مع فقدان الضوء كأداة أساسية سيميائيًا يرمز “كائن الجمر” المركب إلى الاحتراق الداخلي كمدلول للعزلة الثورية بينما تصبح “الذاكرة فوق غصن” علامة طبيعية هاربة تعكس تفكك الدلالة التاريخية وتتحول “الصمت غابة” و”عود كبريت” إلى رموز متناقضة دالة على انهيار النظام السيميائي فيما يعكس “الذئب المطعون” انقلاب الدال إلى مدلول في لعبة تناقضات نارية-مائية وجوديًا تصبح العزلة التي “لا تتسع لضجيج الآخرين” جوهرًا للوجود ككائن مشتعل ومطفأ في نشيج الليل مع صراع عبثي تصقله الريح معكسة تصور سارتر عن الحرية كعزلة مرعبة تكسر الذات لتكتشف اللامعنى ويصبح البكاء الذئبي تمردًا على الحياة كفريسة طاعنة.
وفي هذا السياق تظهر قصيدة “فقدت رأسي في حرب” الجسد المحطم في الهاوية كرمز متكامل للفقد والتمرد والمعرفة المستخلصة من الألم حيث يتحول الفقد الجسدي إلى تجربة وجودية عميقة تكشف هشاشة الإدراك وطبيعة الصراع البشري مع العدو.
تفكك الحرب والمرآة الإدراكية
تحول الذاكرة إلى شظايا عديمة القوة وهنا يولد الفقدان الجسدي تمردًا سيزيفيًا يحتضن الموت كإرث للصمود وإبستمولوجيًا تمثل الحرب كارثة معرفية حيث تصف عبارة “أكسر المرآة فينز دمها من وجهي” الوعي كمرآة محطمة بينما تصبح “شظايا ذاكرة بلا أسنان” معرفة مسننة بالألم عديمة القوة وإنه عندما “فرّت عصافير من رأسي” يظهر تفكك اللغة كأداة مع “صمت الوقت المهدر” كزمن مهدور ويصبح المشي “على رأسي” تجربة تناقضية لإعادة بناء الإدراك الفاشل وسيميائيًا يدل “كسر المرآة” على انفصال الدال عن المدلول وإنه عندما تتحول “العصافير الهاربة” و”المفردات المسجونة” إلى رموز فهي دلالات متناثرة من الرأس كحاوية بينما يصبح “المشي على الرأس” انقلابًا دلاليًا للأعلى والأسفل وقد تصبح “القبور المكشوفة” علامات مفتوحة على الموت كمدلول أبدي للإرث الحربي ووجوديًا يعكس الفقدان الجسدي اغترابًا في حرب كجحيم عبثي وإنه عندما “أصعد إلى أسفل البئر” تتجسد صورة كاموية سيزيفية ويصبح “أحتضن القلب الذي أورثني القبور” إرثًا من الموت يولد تمردًا يرفض الاستسلام أمام التراب مسعورًا.
سجن: الحرية كقفص مفتوح
القفص المفتوح يعكس معرفة معكوسة حيث الهروب يصبح سجناً ذاتيًا، والوحدة العبثية تحول الجراح إلى نظام تراكمي للصمود أمام الفراغ. إبستمولوجيًا يرمز “القفص المفتوح” إلى معرفة ذاتية معطلة حيث “يسجنُني الهروب” كإبستمولوجيا معكوسة مع الجراح من “الحبُّ… الخوفُ… الرمشُ” مصادر للوعي و”أعدُّ جروحي مثلَما أعدُّ الشيْبَ” تحولًا للألم إلى نظام معرفي غير مكتمل في “فضاءاتِ بيتي” سيميائيًا يصبح “القفص المفتوح” رمزًا متناقضًا دالًا على الحرية كسجن مع “الجراح” علامات حادة كـ “نصل” دالة على تفكك الجسد كبنية و”عد الجروح كالشيب” نظامًا دلاليًا تراكمياً بينما “الفضاءات كبيت” رمز للوحدة كفضاء مفتوح-مغلق في لعبة دال ومدلول للاغتراب وجوديًا تكون الوحدة “مثل قلبي” عبثًا خالصًا مع الحب بلا أجنحة والخوف بلا ثوب كجرح مفتوح و”بابُ القفصِ مفتوح” حرية سارترية مرعبة تجرح لا تحرر حيث يعد الشاعر جروحه كسيزيف في رفض لوهم الهروب.
مقاربات فلسفية مختارة
تكشف نصوص دخيل الخليفة عن تداخل الحرية والوجود والزمان مع الفقد والمعاناة بحيث تتحول التجربة الشعرية إلى فضاء تأملي يمزج بين الألم والمعرفة والكينونة. في قصيدة «سجن» يظهر القفص المفتوح كاستعارة للحرية العبثية إذ يتحول الهروب إلى سجن داخلي ويصبح كل جرح يعدّه الشاعر تكرارًا للوعي بالوجود، وهو ما يذكّرنا بسارتر في «الغثيان» حيث لا يمكن للحرية أن تتحقق إلا عبر مواجهة العبث والاغتراب الذاتي، وإنه عندما يُستدعى السجن بوصفه مفتوحًا فإن القيد الحقيقي هو إدراك الذات أمام الفراغ، فكل محاولة للهروب تفضي إلى إدراك العبث في الحرية نفسها.
وعند قراءة «خطوات على عكّاز» في ضوء فلسفة دولوز في «الفرق والتكرار» تصبح الجراح والالتقاط المستمر لشظايا الآخرين من أحلام العابرين إلى دمعة الأم تجليات لتكرار زمني للألم، حيث لا يمثل التكرار مجرد نسخ بل وسيلة معرفية لإعادة بناء الوعي من شظايا التجربة، وإنه عندما تتحول الجراح إلى رموز للوجود يظهر الزمن كعامل مستمر يربط الحاضر بالماضي، فيصبح الألم ذا دلالة معرفية كونه يشكل وعيًا بالاغتراب والفراغ.
والجدير بالذكر أن نصوص دخيل الخليفة تتقاطع مع إيكو في «سيميائية اللغة»، إذ تصبح الرموز مثل القفص والجسد الناقص والعكاز أكثر من مجرد دال على شيء محدد، فهي علامات قابلة للتأويل، وإنه عندما تتكاثر التناقضات بين الدال والمدلول يصبح النص مساحة معقدة من الغياب والحضور حيث تتحول المعرفة إلى عملية مستمرة من القراءة والتأويل، والفقدان إلى وسيلة لفهم الذات والآخر والعالم.
وأخيرًا، يمكن ربط هذه التجربة بفلسفة الغزالي في «إحياء علوم الدين» حيث تتحول الوحدة والعزلة إلى سجن روحي، وإنه عندما يواجه الشاعر فراغه الداخلي ويتأمل جراحه يجد في هذا السجن وسيلة للوصول إلى حضور داخلي أعمق، فيصبح الألم والقيود أدوات للتأمل الذاتي والتحرر الروحي بحيث يتكامل بعده الصوفي مع القراءة الإبستمولوجية والوجودية.
هكذا تكشف نصوص دخيل الخليفة عن تجربة فلسفية متعددة المستويات، حيث يصبح الفقد والمعاناة والغياب ليس فقط شعورًا إنسانيًا، بل تجربة معرفية ووجودية وسيميائية وفلسفية متشابكة تحاكي صراعات الإنسان مع ذاته ومع العالم وتطرح الأسئلة الكبرى حول الحرية والوجود والزمان والمعنى.
تشييد المعنى من ركام الغياب
من خلال القراءة يتجلى أن شعر دخيل الخليفة يحول الفقدان من حالة سلبية إلى أداة فاعلة لإنتاج معرفة مشوهة ولكنها صادقة، وكينونة مغتربة ولكنها صامدة، ودلالة منفصمة ولكنها حية الجسد المشوه والذاكرة الهاربة والرموز المتناقضة تشكل معًا كونًا شعريًا تكون فيه المعرفة مشتقة من الألم، والوجود قائمًا على الصمود في السقوط، والدلالة متجددة في قلب التفكك.
يستلهم هذا الشاعر تراثه العربي من الحزن والمنفى ويصهره برؤى فلسفية غربية معاصرة، ليصبح صرخة مدوية ضد الفراغ. يبقى سؤال الخليفة الأخير مفتوحًا ومؤلمًا: هل يستطيع الشعر، في نهاية المطاف، أن يعيد بناء وطن من الشظايا، أم أن قدره الأبدي هو أن يكون شاهدًا أمينًا على الغياب؟