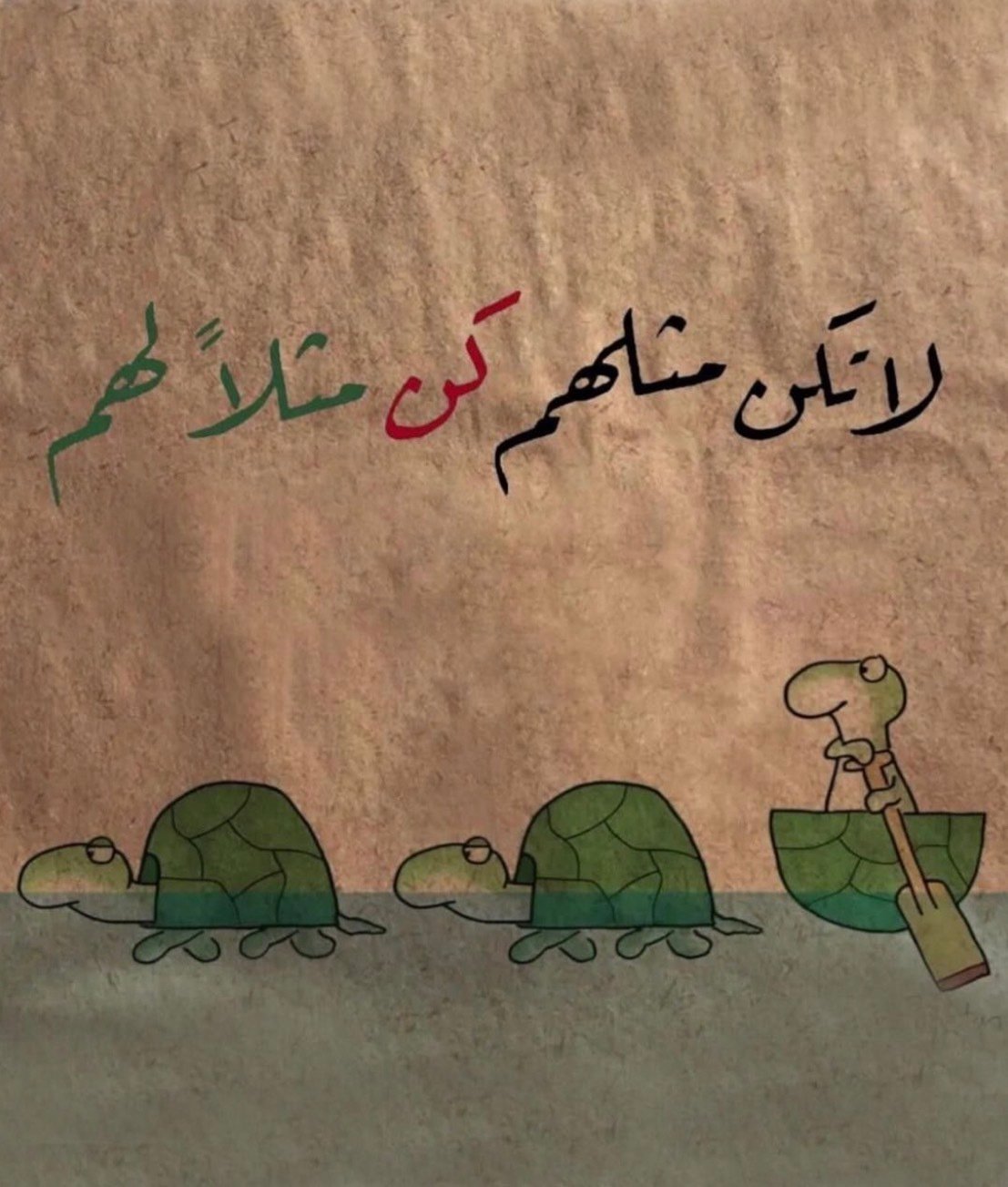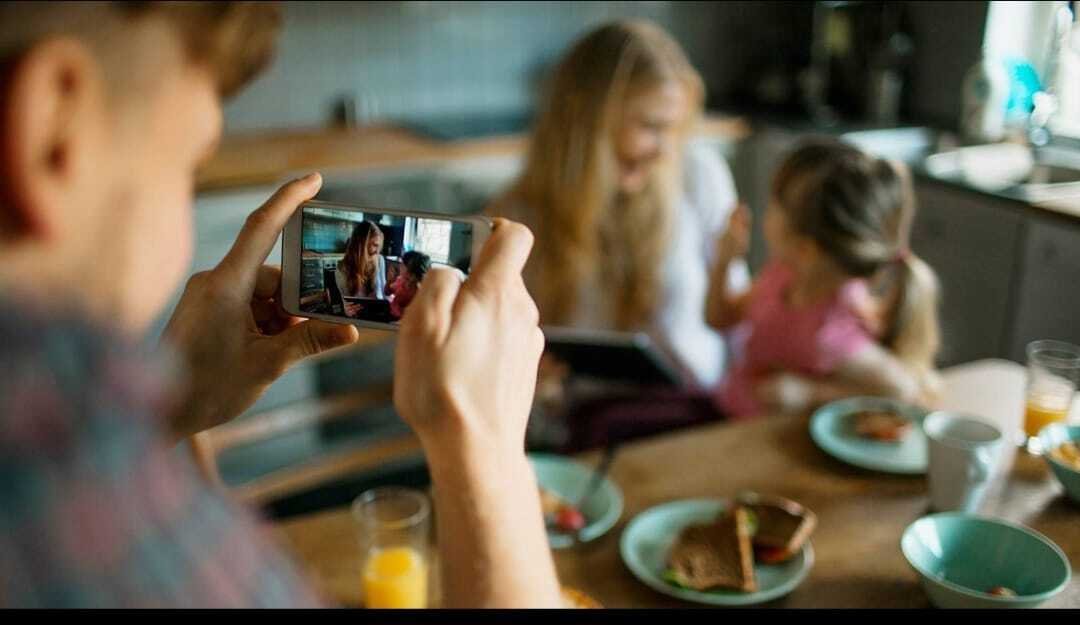لو علمتِ الدار بمن زارها

بقلم الكاتبة د. سوسن توفيق حنفي
لم تكن الطوارئ يومًا مكانًا لمداواة المرضى فقط،
بل ما يميزها أنها دار لا تعرف الزائر قبل أن يدخل، لكن رغم ذلك تشعر بقلبه قبل أن يتكلم.
كنتُ أعمل تلك الليلة وأنا أحمل فقدي بصمت.
فقدتُ أبي قبل فترةٍ قصيرة،
وما زالت روحي تتعثّر بذكراه في تفاصيل لا ينتبه لها أحد.
كنت أظن أنني تعلّمت كيف أوازن بين المهنية وما يعتمل في الداخل.
حتى دخل هو.
مريض وحيد،
يتجه ببطء نحو سرير الطوارئ،
بين ذهول مكتوم، وأملٍ يتشبّث بما بقي.
رفعتُ عيني من خلفه وهو يخطو. لأول وهلة،
شعرت أن قلبي سبقني خطوة،
وأن شيئًا قديمًا، كنتُ أظنه هدأ بعد رحيل أبي،
قد استيقظ فجأة دون إذن.
كان يشبهه…
لا في الهيئة وحدها،
بل في ذلك الوقار الطاغي الصامت،
وفي هيئة الجسد حين يسلّم أمره للقدر،
كما كان أبي يفعل في أيامه الأخيرة.
تقدّمت نحوه وأنا أقاوم ارتباكًا داخليًا لا يُقال،
وشعرتُ أن قلبي منذ فقدت أبي لم يعد يعرف موضعه تمامًا،كأنه صار غريبًا حتى عني.
كَأَنَّ القَلبَ بَعدَهُمُ غَريبٌ
إِذا عادَتهُ ذِكرى الأَهلِ ذابا
نعم يذوب القلب ويتأرجح بين الجوانب حين تعصف به الذكرى فجأة، وتفتح أبوابًا حسبنا أننا أغلقناها بالتصبر وجروحًا ظننا أنها رُتقت وغُشيت بالدموع .
ومع ذلك الذوبان الصامت،أدركتُ أن الليالي لا تُظهر حقيقتها لكل أحد،وأن الفقد وحده هو الذي يعلّم الانسان كيف تتغيّر ملامح الدنيا من حوله
وَلا يُنبيكَ عَن خُلُقِ اللَيالي
كَمَن فَقَدَ الأَحِبَّةَ وَالصَحابا
عندها فقط فهمت لماذا انحنيت بلا وعي لأخلع نعليه كما كنت أفعل مع أبي حين يثقل المرض خطواته.
وخالطتني رغبة طفولية عميقة أن أقبّل رأسه.
كأن قلبي يقول:
“لحظة واحدة فقط… دعيني أعيش ما فاتني.”
ولماذا تمنّيت ولو خيالًا أن أعيش مع أبي تلك اللحظات التي لم يمهلني القدر لها.
نحن أطباء الطوارئ نواجه هذه المشاهد باستمرار،
وما كل موقف إلا عيّنة من قصص الحياة المختلفة
التي تمتلئ بها جعبتنا مع مرور الزمن.
قصص نحتويها، نُحسن التعامل معها،
ثم نحمل أثرها معنا بصمت.
فحين نقف أمام أهل مريض نشرح لهم صعوبة الحالة، أو نناقش قرار عدم الإنعاش،
نستحضر دون وعي لحظات مررنا بها مع أحبّتنا.
وحين نواسي أهل فقدٍ، نواسي في الحقيقة أنفسنا القديمة التي عرفت هذا الوجع من قبل.
الطبيب لا يتجرّد من إنسانيته حين يرتدي معطفه،
بل يحملها معه وقد يهدي السكينة والدفء لمن حوله بمعطفه وهو يرتجف بردًا من الداخل !
ويتعلم كيف يداوي الآخرين، وهو نفسه مكسور !
انها مهنة العطاء فعلًا .
وأثناء رعايتي لذلك المريض ،كان قلبي يهمس بما لا أجرؤ على قوله:
لو أمطرتْ ذهبًا من بعدِ ما ذهبا
لا شيء يعدلُ في هذا الوجودِ أبا
ياليتني الأرضُ تمشي فوقها فأرى
من تحتِ نعلكَ أني أبلغُ الشُهبا
مهما كتبتُ بهِ شعرًا فإنَّ أبي في
القدرِ فوقَ الذي في الشعرِ قد كُتبا
كنتُ أراه أمامي مريضًا، لكن روحي كانت ترى أبي.
وكان كل ما أتمناه أن يمنحني الله دقائقًا أعيشها معه…ولو كانت كاذبة.
عالجت مريضي وتماثل للشفاء وكتبت له الخروج بفضل الله إلى بيته سالمًا.
وفي تلك اللحظة، حين وقفتُ لوداعه عند سريره،
أدركتُ أن بعض اللقاءات لا تأتي صدفة،
وأن بعض المرضى لا يدخلون الطوارئ بوصفهم حالات طبية، بل يدخلونها كأمانة عاطفية
تُعيد إلينا ما حسبناه مضى بلا رجعة.
هناك،
عند لقيا شبيه أبي،
شعرتُ أن المكان نفسه تغيّر، كأن الطوارئ على قسوتها أدركت من زارها تلك الليلة.
ولو علمت الدار بمن زارها
لَفَرِحت واستبشرت،
ثم قبّلت موضع القدم،
وأنشدت بلسان الحال قائلة:
أهلًا وسهلًا بأهل الجود والكرم.
فلم تكن الطوارئ يومًا مكانًا للوجع فقط،
بل دارًا تتّسع للحياة حين تضيق،
وتمنحنا نحن الأطباء فرصة نادرة لنكون شهودًا على لحظات إنسانية خالصة،
نُعطي فيها أكثر مما نملك، ونستعيد فيها، دون قصد، من فقدناهم في هيئة من يحتاجوننا.
وفي تلك الليلة، لم أُداوِ مريضًا فحسب، بل صافحت ذكرى، وهدّأت قلبًا،
وتعلّمت من جديد أن بعض الرحمة التي نمنحها للآخرين إنما تعود إلينا
تقول لنا:
ما زال للأب حضور في كل تفاصيل الحياة وان كان غائبا بجسده.