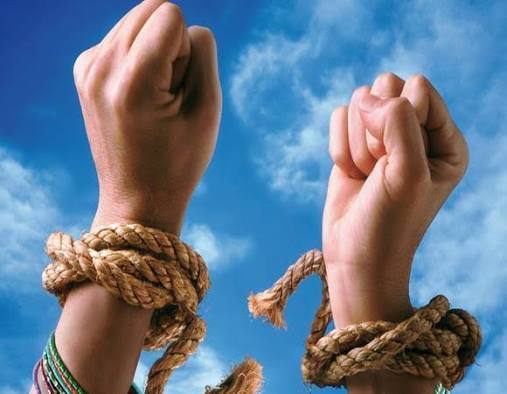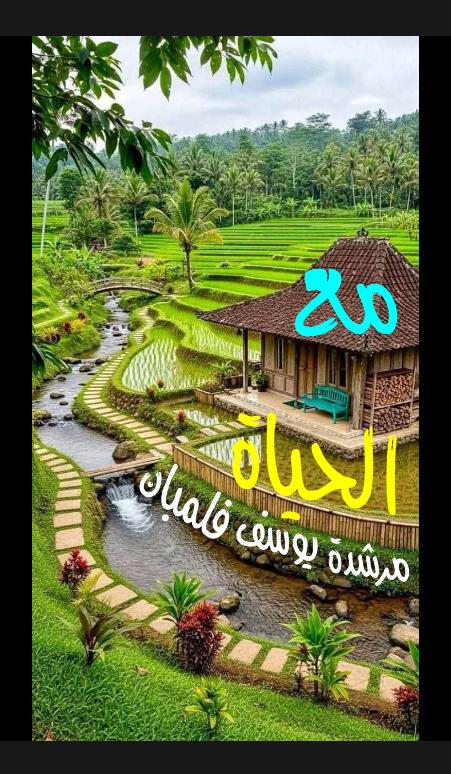في رحاب العربية

بقلم : د. رغدة الإدريسي
لماذا نتعلم اللغة العربية؟
من الطبيعي أن يُلحّ هذا السؤال في هذه الأيام التي علا فيها شأو العلوم التطبيقية، وصار قوام حياة الإنسان هذا التقدم التقني المذهل الذي نعيشه.
فبينا وصل الإنسان إلى الذكاء الاصطناعي الذي يؤلف البحوث، وينشئ العروض، ويجيب المعضلات العلمية في ثوان، لا بد لنا أن نتساءل عن مدى حاجتنا لتعلم الفاعل وإعرابه، والنواسخ وحالاتها، وتقدم الخبر على المبتدأ وعلاماته. . والحقيقة أن هذا السؤال منوط بكل العلوم الإنسانية كذلك، وهي العلوم التي تشكل الهوية؛ أي هي التي تجعل منك نسخة مميزة عن غيرك من البشر، وهي التي تصنع مبادئك وقيمك، وتكون تفكيرك، وهي التي تصنع قراراتك في المواقف الأخلاقية، وهي التي تجمعك مع أشباهك وأمثالك ممن تكلموا اللغة نفسها فحملوا القيم ذاتها.
فاللغة ليست نحوا وإعرابا وأدبا فقط، وإنما هي قالبٌ ثقافيٌ متكامل، يكوّن جوهر الإنسان ويصنعه، وهذا الإنسان هو من يصنع هذه الحضارة العلمية للأمم، إذ لاتوجد حضارة عظيمة عبر التاريخ ازدهرت علميا إلا وقد ازدهرت أدبيا ولغويا وفكريا أيضا.
وإنه لمن المحزن أنه في الوقت الذي تحاول فيه المؤسسات التعليمية في العالم العربي الانسلاخ من ربقة تعلم العربية، والسعي الحثيث لتخفيض حصصها، لا يزال العالم الغربي يعمل حثيثا في مجال اللغويات وعلومها، وينشئ الأقسام العلمية التي تدرسها، ويبحث عمّ يجعل لغاتٍ ما تموت وتنتهي، ولغاتٍ أخرى تعيش وتستمر، ويضع كل يوم طرائق جديدة لتعليم اللغة وتسهيلها.
لقد وضع الغرب اللغة على طاولة التشريح، ولبسوا لأجلها القميص الأبيض وأدخلوها المعامل، وشرّحوا أعمق أعماقها، وساروا في ذلك خطوات واسعة، فعلى سبيل المثال وضعوا أبجدية صوتية دولية (IPA ) وهي أبجديةٌ أنشئت بواسطة الجمعية الصوتية الدولية، لتصنيف الأصوات بناء على مكان وكيفية تشكيلها في الجهاز الصوتي البشري، إذ وضعت رموزا أبجدية صوتية لجميع أصوات لغات العالم المنطوقة اليوم؛ مما يؤهل المتمكن منها لقراءة أي نص بأي لغة، ما دامت كتبت بهذه الرموز، ويهدف هذا العمل إلى تسهيل تعليم وتعلم اللغات، وتسهيل الحفاظ على التراث الإنساني، ونقله لعدة لغات.
لقد أدخل الغرب اللغة المعمل، وأخذوا يقيسون أصوات حروفها ويدونونها، لأنهم اكتشفوا أن من أسباب موت اللغة؛ هو تغيّر نطق أصواتها عبر السنين، فعملوا على تدوين سجلات صوتية بطريقة علمية؛ للمحافظة على اللغات الحية من الموت والزوال، والعجيب أن علماءنا المسلمين قاموا بهذا الدور منذ أكثر من ألف سنة؛ لما دوّنوا مخارج كل حرفٍ عربيٍ بالتفصيل، ولا يزال يُتعلم هذا العلم (التجويد) إلى يومنا هذا، وبه يستطيع غير الناطق بالعربية أن يتلو القرآن تلاوة فصيحة دون أن يعرف معنى ما يقرأ.
بل لقد بلغ من اهتمام العالم الغربي باللغة وتسخير العلم الحديث لها، أن قاموا بدراسة الدماغ البشري للناطقين بلغات مختلفة، متسائلين عمّ إن كانت اللغة تؤثر على طريقة وكيفية عمل الدماغ.
فقد كشفت دراسة ألمانية أن أدمغة المتحدثين بالعربية تختلف عن أدمغة المتحدثين بباقي اللغات؛ فبعد مسح أدمغة 47 مشتركا بالرنين المغناطيسي، وجدوا أن الناطقين بالعربية لديهم ارتباط أقوى بين نصفي الدماغ الأيمن والأيسر أي ما يسمى بالجزء الصدغي، ولديهم دوائر عصبية مختلفة لمعالجة اللغة العربية تختلف عن الدوائر العصبية التي تعالج اللغة الألمانية، والسبب في ذلك هو اتجاه العربية من اليمين إلى اليسار، واعتمادها على الاشتقاق من الجذر الواحد، واعتماد كتابتها على وصل الحروف وتشابكها، هذه الخصائص اللغوية في النطق والكتابة تعمل على تشغيل نصفي الدماغ معًا، عكس اللغات التي تتجه من اليسار إلى اليمين، و تعتمد على العلاقات الدلالية وليست الجذرية، فهذه اللغات المذكورة تشغل الجزء الأيسر من الدماغ فقط، وهو الجزء المسؤول عن المعالجات النحوية بين الجمل، مما يمكّن الناطقين بلغات أخرى كالألمانية من فهم الجمل المعقدة أكثر من الناطقين باللغة العربية، ولعل هذا هو السبب الذي يجعلنا نحن القراء العرب لا نفهم الكتب المترجمة، ولا نفهم ماذا يريد الكاتب أن يقول، فتبدو لنا الصفحات مكرورة الكلام دون معنى جديد محدد.
بل إن من أعجب الدراسات هي دراسة أجريت على المريض اللبناني (ZT ) وهو ثلاثينيٌ ناطقٌ بالعربية لغةً أم، وبالفرنسية لغةً ثانيه، أصيب (ZT) بجلطة دماغية أدت إلى تطوير ديسلكسيا عميقة، أي عسر قراءة عميق، قام باحثان لغويان بدراسة وتحليل أعراض عسر القراءة التي أصيب بها المريض، ومقارنة أعراضها بين اللغتين العربية والفرنسية، فوجدوا أن هذا المرض يتأثر بخصائص اللغة، فقد كان المريض عند اختباره في اللغة العربية، يخلط باستبدال الكلمات بكلمات من نفس الجذر والوزن؛ فيقرأ مسلّمات: سلامات، وكَتَبَ :كُتُبَ، كما كان يخلط بين الحروف المتشابهة كتابيا، فيقرأ مثلا: بيت: ثيت، فالدماغ يتعامل مع الكلمة العربية باعتبارها مركبة من جذر + وزن، بينما كان عسر القراءة في اللغة الفرنسية مختلفا يظهر في الصوت: فكلمة pain يقرأها bain ، فالخلل هنا صوتي بسبب تقارب الأصوات، أي أن الدماغ يفشل في المعالجة الصوتية التحليلية فرنسيا، ويفشل في المعالجة الكتابية عربيا بينما يحافظ على وزن الكلمة أو جذرها، والخلاصة من الدراسة أن أمراض الدماغ تتأثر باللغة، إلى هذه الدرجة تؤثر فينا اللغة و تصنعنا.
يعني أن دماغك يا عزيزي القارئ العربي؛ يفكر بالعربي، ويمرض بالعربي، ويعمل بالعربي.
إن القالب اللغوي العربي الغني بقصص العرب، وسيرهم وعاداتهم وتراثهم ودينهم الإسلامي، هو ما يصنع هويتك كإنسان، وهو ما يشكّل الوجه الأخلاقي والإنساني للأوطان والحضارات.
ولذلك جعل الله تعالى معجزة نبيّه صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب المبين، بلغته العربية الخالصة، فياله من شرف أن تكون ناطقا بهذه اللغة، تقرأ بها رسائل ربك، وتفهم كلامه، وتقف خلف الإمام فتفهم صلاتك ودعائك، وطوبى لك أنك لا تزال تنطق واحدة من أقدم لغات الأرض التي لا تزال حية إلى اليوم، بينما العمر الافتراضي لأغلب لغات العالم لا يتجاوز 150 سنة.
إنها لمنحةٌ عظيمةٌ لا يعرف قيمتها إلا مسلم صادق حُرِمها، ويتوق إلى تعلّمها ما كان له إلى ذلك سبيل.